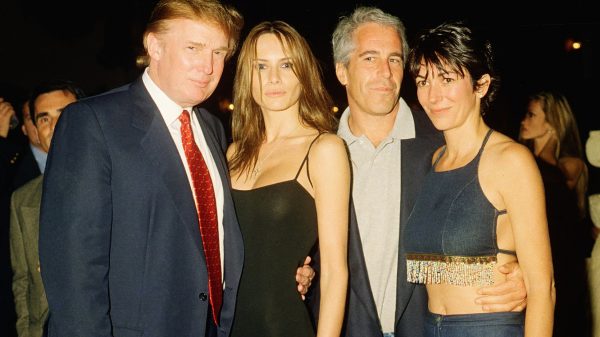لعقود من الزمان، كانت شرعية حزب الله ترتكز على فرضية مفادها أن سلاحه وحده قادر على الدفاع عن لبنان من خلال مقاومة إسرائيل. وهو الدور الذي كررته المجموعة خلال العامين الماضيين في “حرب الدعم” المدمرة التي شنتها على غزة. ومع ذلك، فقد جاء هذا الصراع بثمن مذهل، وبلغ ذروته ليس فقط باغتيال زعيمه الشهير حسن نصر الله في سبتمبر 2024، ولكن أيضًا باحتلال عسكري إسرائيلي جديد لأراضٍ استراتيجية داخل جنوب لبنان.
ومن هذه المواقع، لا تظهر القوات الإسرائيلية سوى القليل من الإشارات على المغادرة، وبدلاً من ذلك، يبدو أنها تحتجز الأرض كرهينة، وتقايض ضمنياً عودتها بنزع سلاح حزب الله في المستقبل.
والآن، يهدد الاحتمال المفاجئ للتوصل إلى اتفاق في غزة، بوساطة إدارة دونالد ترامب، بهدم هذا الصرح بالكامل. ومن خلال إجبار حماس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن نزع سلاحها، فإن الخطة تجرد حزب الله من ذريعته الأساسية للتشدد عبر الحدود. والنتيجة هي أن الترسانة الهائلة التي يمتلكها الحزب، والتي تم تبريرها ذات يوم كدرع للمنطقة وللبنان، أصبحت الآن أشبه بخنجر مصوب إلى قلب الدولة اللبنانية نفسها. لقد تحول السؤال من ما إذا كان حزب الله سيقاتل إسرائيل ومتى، إلى كيف ومتى سيواجهه لبنان نفسه.
ووصف زعيم حزب الله الجديد نعيم قاسم مؤخراً خطة ترامب بأنها “مليئة بالمخاطر”. ومع ذلك، وفي إطار الابتعاد السياسي، أذعن لحماس قائلاً: “في نهاية المطاف، المقاومة الفلسطينية وحماس وجميع الفصائل هي التي تناقش وتقرر ما تراه مناسباً”.
والرسالة واضحة لا لبس فيها: غزة هي غزة، ولبنان هو لبنان. لكن هذا هو التمييز الذي لم تعد واشنطن وحلفاؤها على استعداد للقبول به. إن المساحة المخصصة للاستثناء المسلح لحزب الله، والتي تقلصت بالفعل بعد الحرب المدمرة التي أعقبت حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قد اختفت الآن تقريباً.
وفي هذا الفراغ، صعدت دولة لبنانية تحاول القيامة. لقد شرعت حكومة الرئيس جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام في تنفيذ ما يعتبره كثيرون مشروعاً جريئاً ومحفوفاً بالمخاطر: إعادة تأكيد احتكار الدولة للقوة الشرعية. في سبتمبر/أيلول، أقر مجلس الوزراء خطة مرحلية، صاغتها القوات المسلحة اللبنانية، لنزع سلاح جميع الجماعات غير الحكومية. وقد تم تقديم التقرير الشهري الأول حول تنفيذه إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وهي وثيقة ستكون بمثابة مقياس لقدرة الدولة على ترجمة المرسوم إلى واقع ملموس.
بالنسبة لشخصيات مثل سمير جعجع، زعيم حزب القوات اللبنانية، فإن هذه فرصة لكسر ما يعتبره دورة مستمرة منذ 40 عامًا من الاستيلاء على الدولة. وبوصفه فصيلاً قوياً من الطائفة المسيحية في لبنان، فإن موقف جعجع لا هوادة فيه. وأعلن في خطاب ألقاه مؤخراً أن حرب حزب الله مع إسرائيل “جلبت الدمار والخراب والتهجير وأدت إلى احتلال جديد”، معتبراً أن “أقصر طريق لإخراج إسرائيل من الجنوب ووقف هجماتها هو إقامة دولة حقيقية في لبنان”.
ومن الأهمية بمكان أن جعجع يحاول انتشال الطائفة الشيعية من قبضة الحزب، بحجة أن مصيرهم ليس مرادفاً لمصير حزب الله. وأعلن مخاطباً حزب الله وقاعدته: “إن الشيعة لم يأتوا إلى لبنان معكم، وهم بالتأكيد لن يغادروا معكم!… ثقوا بأن الدولة التي لنا ولكم هي الوحيدة التي تحميكم”. بالنسبة لجعجع، فإن التنافس على السيادة هو لعبة محصلتها صفر، ويجب على الدولة أن تفوز.
لكن لسنوات عديدة، كان الثقل الموازن الأساسي لموقف جعجع داخل المجتمع المسيحي يأتي من أهم حليف مسيحي لحزب الله: التيار الوطني الحر، الذي أسسه الرئيس السابق ميشال عون. وقد وفّرت اتفاقية مار مخايل لعام 2006 لحزب الله غطاءً سياسيًا لا غنى عنه، مما أدى إلى كسر المعارضة المسيحية وإضفاء الشرعية على وضعه كقوة مقاومة داخل الدولة.
ولكن حتى هذا التحالف قد ذبل في أعقاب حرب ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي سحقت حزب الله وألحقت الدمار بلبنان. والآن، يرسم خليفة عون، جبران باسيل، علناً مساراً جديداً. وقال باسيل مؤخراً إن «المقاومة أخطأت وأخذت البلد إلى مكان ما كان يجب أن تأخذنا إليه».
لكن الانتقادات كانت محسوبة بعناية. ومن دون قطع العلاقات التاريخية مع حليفه السابق بشكل كامل، دعا إلى “الحوار وعدم المواجهة”، ونزع اللوم من خلال تأطير القضية على أنها قضية “ارتكب فيها الجميع أخطاء”.
لكن الواقع الجديد لا لبس فيه، وهو أن التيار الوطني الحر يتخلص من مسؤولية التحالف غير المشروط مع حزب الله الضعيف، ويحاول احتلال أرضية وسطية جديدة كوسيط. ومع ذلك، فإن التأثير هو نفسه: تعمق العزلة السياسية لحزب الله.
وهذا التفضيل لـ”الحوار الهادئ والتوافقي” هو استراتيجية يتبناها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وباعتباره زعيماً لحركة أمل، الحليف الشيعي الرئيسي لحزب الله، فقد تمكن من إدارة التناقض المتأصل بين الدولة و”المقاومة” من خلال ضمان توجيه الصراعات إلى عملية سياسية، مهما كانت غير حاسمة.
لكن نظام إدارة الأزمات هذا أصبح غير فعال. لقد تم تصميمه لنظام بيئي سياسي لم يعد موجودا، ويواجه الآن إنذارا نهائيا تقوده جهات فاعلة دولية لا تتسامح مع طقوس بناء الإجماع البطيئة التي يعتمد عليها النظام اللبناني.
وفي هذه الساحة المشحونة، يخطو المبعوث الأميركي الصريح، والصريح بشكل مذهل في بعض الأحيان، توم باراك، قطب الأسهم الخاصة من أصل لبناني. وكانت رسالته، التي ألقاها في العلن وفي السر، متسقة: يجب على الدولة اللبنانية أن تؤكد نفسها، وإذا فشلت، فلا يمكنها أن تتوقع الحماية. “هل تعرف من سينفذ (نزع السلاح)؟” سأل في مقابلة الشهر الماضي. “امشوا عبر تلك الحدود. هل ترى أين تقع القدس؟ القدس ستعتني بحزب الله نيابةً عنكم”.
لقد اتخذت واشنطن خيارها: فهي ستمكن الجيش اللبناني من القيام بهذه المهمة، حيث قامت مؤخرًا بإرسال 230 مليون دولار كمساعدة أمنية إلى بيروت قبل إغلاق الحكومة الأمريكية مباشرة، لكنها تحتفظ بإسرائيل كاحتياطي باعتبارها الضامن النهائي لسياستها. إسرائيل من جانبها لم تقدم أي تنازلات. فهي تواصل ضرباتها الروتينية، مما يؤدي بشكل منهجي إلى إضعاف ما تبقى من قدرات حزب الله، ولا ترى أي حافز لتقديم الجزرة عندما تثبت العصا فعاليتها.
وفي الوقت نفسه، يوجه حزب الله رسالة مرونة وتحدي بينما ينخرط في الوقت نفسه مع مؤسسات الدولة التي يزدريها علناً. لاحظت مصادر أمنية تعاون حزب الله مع الجيش اللبناني في جنوب لبنان ورده على احتواء الأسلحة شمال نهر الليطاني من خلال إخلاء عدة مواقع، بينما يشارك نوابه ووزراءه في المسرح البطيء لسياسة التوافق اللبناني.
ومع ذلك، فإن هذا أداء مصمم لتزويد الدولة وداعميها الدوليين بما يكفي من المواد للمطالبة بالتقدم دون المطالبة بالاستسلام الفعلي. ومن خلال تقديم تنازلات محدودة للجيش اللبناني، يُظهر حزب الله درجة من المسؤولية تخفف الضغط من بيروت مع الحفاظ على أصوله العسكرية الأساسية.
ولكن نهاية اللعبة بالنسبة لحزب الله تظل غير مكتوبة، وذلك على وجه التحديد لأنها تتوقف على الإجابات على سلسلة من الأسئلة المتشابكة. الأول هو ما إذا كان اتفاق غزة لن يصمد فحسب، بل سيتوج بنزع سلاح حماس بشكل ملموس، وبالتالي إنشاء سابقة لا مفر منها بالنسبة للبنان. والسؤال الثاني هو مدى تصميم واشنطن: فهل ستواصل استغلال تفوقها وتجيز حقاً استخدام المطرقة الإسرائيلية لفرض نتيجة مماثلة؟
وأخيراً، هناك مسألة مدى امتثال إسرائيل، فهل توفر حماس بعد نزع سلاحها القدر الكافي من الأمن لإسرائيل حتى تتمكن من تلبية الطلب الأميركي بالانسحاب من جنوب لبنان؟ إن التحرك الأكثر ذكاءً في مواجهة مثل هذا الغموض العميق هو ذلك الذي يقوم به حزب الله: العب مع الوقت وانظر كيف يتم إعادة رسم الخريطة.
إذن، هل اتفاق غزة يجعل لبنان أقرب إلى احتكار القوة؟ الإجابة هي نعم متناقضة، ولكن ليس بالطريقة التي قد نأملها. فهو لا يجعل نزع السلاح أسهل في حد ذاته. وبدلا من ذلك، فهو يجعل الصدام من نوع ما أمرا لا مفر منه على نحو متزايد، ويتوقف توقيته وشدته على كيفية تقدم صفقة غزة.
بالنسبة لواشنطن، فإن التوصل إلى صفقة مكتملة في غزة، والتي تصل إلى مرحلة نزع سلاح حماس، من شأنه أن يفتح مجالاً دبلوماسياً للتركيز على ملف لبنان، وهو ما من شأنه أن يؤسس ليس فقط للزخم، بل أيضاً لسابقة قابلة للتكرار لإجبار جهة فاعلة أخرى غير حكومية على نزع سلاحها.
بالنسبة لإسرائيل، فإن الجبهة الجنوبية الهادئة تسمح لاهتمامها العسكري بالتحول نحو الشمال. والأهم من ذلك، تحقيق نزع سلاح حماس من خلال تسوية سياسية بعد إن شن حملة عسكرية وحشية يخدم كدليل قوي على عقيدة استراتيجية أساسية: وهي أن القوة الساحقة، وليس التنازلات عن طريق التفاوض، هي الحكم النهائي على أمنها. وهذا من شأنه أن يترك شهية قليلة لاتباع نهج أكثر ليونة وتصالحية مع حزب الله.
إن الحيز المتاح أمام حزب الله للمناورة، وهو عالق بين عزلة سياسية داخلية متزايدة العمق، والضغوط الأميركية المتواصلة، والشبح الدائم المتمثل في تجدد الحملة العسكرية الإسرائيلية، يتقلص بسرعة. إن التوصل إلى صفقة ناجحة في غزة، مدفوعة بالقوة المميزة لإدارة ترامب التي تسعى إلى تحقيق نصر محدد للإرث، لن يكون مجرد نكسة أخرى، بل سيكون المنعطف الأخير للمسمار الذي يجعل موقف الحزب باعتباره “مقاومة” مسلحة غير مقبول في النظام الإقليمي الجديد.