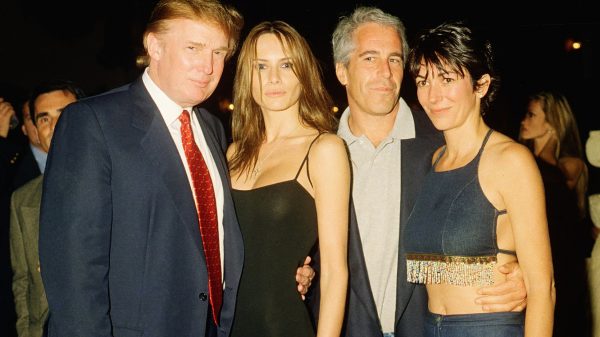عندما افتتح الملك محمد السادس السنة البرلمانية المغربية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، كانت تلك اللحظة تحمل ثقل التاريخ الهادئ. في عالم يتسم بالتقلبات السياسية والإرهاق الأخلاقي، قدم العاهل المغربي شيئا لا يزال عدد قليل من القادة قادرين على تحقيقه: رسالة الإدانة والتوازن والثقة.
وبعيداً عن كونه خطاباً احتفالياً، فقد كان الخطاب بمثابة إعلان نوايا – بأن المغرب، الثابت في مساره الإصلاحي، يدخل الآن مرحلة جديدة من الأداء والعدالة والثقة بالنفس الاستراتيجية.
على مدى أكثر من عقدين من الزمن، برز المغرب في شمال أفريقيا لاستمراريته في الإصلاح – الدستوري والاجتماعي والاقتصادي والبيئي. ويأخذ الخطاب الملكي لعام 2025 هذا الإرث إلى أبعد من ذلك. ويدعو إلى الانتقال من سياسة الإعلان إلى سياسة الإنجاز.
إن رسالة الملك المركزية عملية بقدر ما هي طموحة: فلابد أن يقاس أداء الحكومة الآن من خلال نتائج ملموسة ــ من خلال الفارق الحقيقي الذي تحدثه السياسة العامة في حياة الناس.
ويشير هذا التحول إلى نضج جديد في نموذج الحكم في المغرب. إنه إصرار على أن المصداقية والشرعية يجب أن تعتمد على النتائج، وليس الخطابة – وهي الفلسفة التي تضع المغرب في طليعة الدول الناشئة القائمة على الأداء في المنطقة.
وفي سياق عالمي حيث يؤدي عدم المساواة إلى تغذية الانقسام، يبرز النهج الذي يتبناه المغرب في التعامل مع العدالة – الاجتماعية والإقليمية – ليس باعتبارها مفردات أخلاقية، بل كاستراتيجية وطنية.
إن إصرار الملك محمد السادس على تقليص الفوارق بين المناطق ـ بين الساحل والجبال، والمدن والواحات ـ يعكس حقيقة أوسع: وهي أن العدالة هي المحرك الأقوى للاستقرار في المغرب.
ومن خلال ترسيخ التماسك الإقليمي في السياسة بدلا من العمل الخيري، نجح المغرب في تحويل التنمية إلى شكل من أشكال الأمن الوطني. هذه هي بنية “المغرب الصاعد” التي وصفها الملك ــ الدولة التي تبني السلطة من خلال الشمول والتماسك، وليس المركزية.
وفي عصر تراجع الثقة في المؤسسات، يتميز نموذج الحكم في المغرب بعموده الفقري الأخلاقي. إن دعوة الملك إلى “ثقافة النتائج” كانت أيضاً دعوة إلى ثقافة النزاهة – ثقافة تحدد فيها الكفاءة والمسؤولية والغرض الأخلاقي الخدمة العامة.
ولم تكن الخاتمة الروحية للخطاب – “فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره” – لم تكن زخرفا دينيا. لقد كان بمثابة تذكير بأن الأخلاق في المغرب هي أساس السلطة.
إن هذا التوليف بين الإيمان والبصيرة ـ وهو الأخلاق السياسية المتجذرة في الضمير ـ أصبح نادراً على نحو متزايد في قيادات العالم. وهو ما يمنح الاستقرار المغربي شرعيته المميزة: فهو يرتكز على الثقة، وليس الخوف؛ في الاستمرارية وليس في الرضا.
تمثل فلسفة التنمية في المغرب – الحديثة، ولكن ذات الجذور العميقة – ردا هادئا على الاختيار الزائف بين التقدم والهوية.
إن تركيز الملك على التحول الرقمي، والرعاية البيئية، والإدارة المستدامة للمساحات الساحلية والريفية يسلط الضوء على عقيدة وطنية واضحة: التحديث يجب أن يكون إنسانيا، وليس متجانسا.
وبينما تسعى الدول الأخرى إلى تحقيق النمو بأي ثمن، فإن المسار الثابت للمغرب نحو التحديث المسؤول يجمع بين الطموح التكنولوجي والثقة الثقافية.
إنه نموذج يوضح أن التنمية يمكن أن تكون مبتكرة وأخلاقية على حد سواء – عالمية في نطاقها، ومحلية في روحها.
بالنسبة للمراقبين الدوليين، أكد الخطاب الملكي لعام 2025 ما أصبح واضحا بشكل متزايد: لقد تطور المغرب ليصبح نقطة مرجعية للاستقرار والتوازن والحكم الهادف.
لقد أظهر أن القوة المؤسسية والقيادة الأخلاقية من الممكن أن يتعايشا، وأن الاستمرارية، عندما تسترشد بالرؤية، لا تعني ركوداً بل قوة.
وفي منطقة حيث تحدد التقلبات غالبا الخطاب السياسي، يقدم المغرب بديلا مقنعا: نظام ملكي يحكم بالانضباط، وديمقراطية تنضج من خلال الأداء، ودولة تقيس نجاحها في العدالة بقدر ما تقيس نجاحها في النمو.
يمثل خطاب الملك محمد السادس الأخير بداية ما يمكن أن نطلق عليه عصر الثقة الاستراتيجية في المغرب.
وبعد أن حققت الاستقرار المؤسسي والمصداقية الدولية، تتجه المملكة الآن نحو التعزيز الاستراتيجي ــ فن تحقيق التحول طويل الأمد من دون التضحية بالوئام الاجتماعي أو البوصلة الأخلاقية.
إن الدرس الذي يقدمه المغرب هو درس عالمي: وهو أن الحكم المتجذر في العدالة يمكن أن يكون فعالا؛ وأن التحديث المرتكز على الثقافة يمكن أن يكون مستدامًا؛ ولا تزال تلك القيادة التي تسترشد بالنزاهة قادرة على الإلهام.
وفي عصر يتسم بالتشرذم، يقف مسار المغرب بمثابة تذكير بأن وضوح الهدف لا يزال هو أعلى أشكال السلطة.