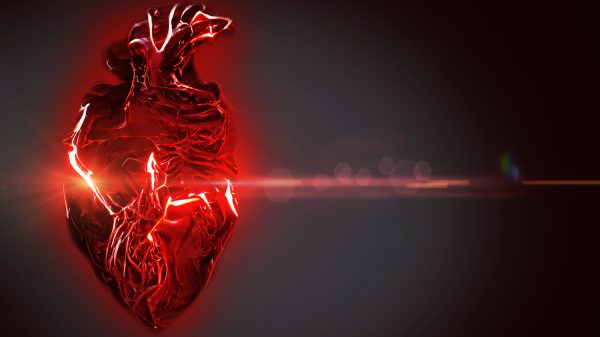مثل شبح في الليل، تسلل بلال شوربا، الفنان الذي يلقبونه بـ “بانكسي السوري”، من بين أنقاض داريا ليرسم لوحاته الجدارية، مدعواً أن لا تكتشفه مدفعيات بشار الأسد.
عند عودته من المنفى إلى واحدة من مهد الثورة السورية المدمرة – المدينة الوحيدة التي فقدت جميع سكانها خلال الحرب الأهلية التي دامت ما يقرب من 14 عاما – اندهش من بقاء بعض أعماله.
على جدار منزل مدمر، تظهر إحدى لوحاته الجدارية المثقوبة بالرصاص، “سيمفونية الثورة”، تطورها المأساوي من المثالية اللاعنفية إلى الموت بلا هوادة – امرأة تعزف على الكمان بينما يستهدفها المسلحون المؤيدون والمناهضون للأسد ببنادق الكلاشينكوف.
وقال شوربا (31 عاما) إن بقاءها في حد ذاته يعد “انتصارا”. ورغم المجازر، ورغم قيام الأسد بإجبار أهالي داريا على ترك منازلهم، “على الرغم من منفانا، بقيت هذه الجداريات البسيطة، وذهب النظام”.
تحتل داريا مكانة خاصة في قصة الثورة السورية.
على بعد سبعة كيلومترات فقط (أربعة أميال) من العاصمة دمشق وعلى مرمى البصر من قصر الأسد الرئاسي المترامي الأطراف، سلم سكانها الورود للجنود الذين تم إرسالهم لقمع احتجاجاتهم السلمية في مارس 2011.
لكنهم دفعوا ثمنا باهظا لتحديهم. قُتل ما لا يقل عن 700 شخص في واحدة من أسوأ المذابح في الحرب في أغسطس 2012، عندما كان الجنود يتنقلون من منزل إلى منزل لإعدام أي شخص يعثرون عليه.
وتلا ذلك حصار مروع دام أربع سنوات، حيث تم تجويع المدينة وقصفها وقصفها بالبراميل المتفجرة، حتى كسرت قوات الأسد المقاومة في عام 2016 وأفرغت المدينة من سكانها.
ولم يُسمح لأي واحد من سكانها البالغ عددهم 250 ألف نسمة قبل الحرب بالبقاء، وأُجبر العديد منهم على العيش في المنفى.
جاء شوربا إلى داريا من دمشق المجاورة في عام 2013 للانضمام إلى المتمردين، ولم يكن مسلحًا بأي شيء سوى “ملابس تكفي ليومين أو ثلاثة أيام وأقلام رصاص وكراسة رسم” ونسخة من كتاب “البؤساء” لفيكتور هوغو باللغة العربية.
وبقي لمدة ثلاث سنوات، يتحمل الحصار والقصف، ويأكل الحشائش والأعشاب البرية من أجل البقاء، حتى تم إجلاؤه هو والمقاتلون الآخرون مع السكان المتبقين إلى شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون في أغسطس 2016.
وفي نهاية المطاف، شق طريقه إلى تركيا المجاورة حيث صقل فنه.
هناك الكثير للقيام به في داريا الآن وقد عاد. لكن شوربا يريد أن يبدأ بالرسم على الجداريات العملاقة التي تمجد عائلة الأسد والتي لا تزال تحدق من الجدران.
– لا تنتظر المساعدة –
سُمح للنساء والأطفال والرجال الذين يمكنهم إثبات عدم تورطهم في المعارضة بالعودة ببطء إلى داريا اعتبارًا من عام 2019. لكن كان على معظم الرجال الانتظار إلى ما بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر 2024.
وقد عاد الكثيرون منذ ذلك الحين – الأطباء والمهندسون والمدرسون والعمال والمزارعون – وغالباً ما جلبوا معهم مهارات جديدة تعلموها في الخارج أو أموالاً تم جمعها من المغتربين للمساعدة في إعادة البناء. ويعيد آخرون تجربة العيش في ظل نظام ديمقراطي إلى بلد لم يعرفه قط.
يتحدث الجميع في سوريا عن روح داريا التي لا تقهر، وشعبها معروف منذ زمن طويل بروح النهوض والانطلاق.
ولكن كيف يمكنك تربية أسرة في مدينة حيث تم تدمير 65 بالمائة من المباني – وفقًا لدراسة أجرتها جمعية المهندسين الأمريكيين السوريين – وتعرض 14 بالمائة أخرى لأضرار بالغة؟
وتعاني المدينة من نقص في الكهرباء والمياه، ولا يعمل سوى ربع آبار المدينة. وفي بعض المناطق تتدفق مياه الصرف الصحي إلى الشارع.
ومع ذلك، لم يتردد حسام لحام للحظة في إعادة عائلته الصغيرة، وهي الأصغر بين بناته الثلاث التي ولدت في وقت سابق من هذا العام بعد التحرير.
كان زعيم المجتمع المدني البالغ من العمر 35 عامًا، أحد آخر الأشخاص الذين غادروا المدينة في عام 2016، وكان من بين أوائل العائدين. قام بتنظيم الإغاثة الغذائية خلال الأيام الأولى للحصار وأنهى الحصار كقائد عسكري.
وقال لحام لوكالة فرانس برس “نحن الوحيدون القادرون على إعادة بناء بيوتنا”. “إذا انتظرنا المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، فربما لم نتمكن من العودة أبداً”.
كما أعاده الموتى. لقد فقد لحام أكثر من 30 من أصدقائه وأقاربه، وهو يشعر بشدة بالدين المستحق على “التضحيات التي قدمتها داريا لاستعادة حريتها”.
وهو الآن متطوع في الإدارة المدنية للمدينة، وهو حريص على إظهار أن الحياة تستمر، حتى في أكثر الظروف خطورة. عادت إحدى العائلات إلى شقة في الطابق العلوي على الرغم من اختفاء معظم الجدران الخارجية.
وتتحول بعض المناطق إلى خلية من النشاط، حيث يقوم العمال بإصلاح الأسطح أو إصلاح الواجهات المتضررة من القنابل أو إصلاح مضخات المياه. كما عادت العديد من ورش الأثاث في المدينة، والتي اشتهرت بها منذ فترة طويلة، إلى العمل.
لكن أحياء بأكملها لا تزال مهجورة، مع القليل من الأنقاض والهياكل العظمية للمباني السكنية.
– مستشفيات مدمّرة –
ولا تعمل أي من مستشفيات داريا الأربعة.
تعرض المستشفى الوطني في المدينة، الذي كان يخدم في السابق مليون شخص، للقصف في عام 2016. ولم يتبق منه سوى قشرته الخرسانية المطلة على منطقة الخليج المدمرة بالكامل. وحتى الأنابيب النحاسية وكابلات الكهرباء تعرضت للنهب بعد سيطرة قوات الأسد على المدينة.
وقال لحام إنه “لا يوجد مستشفى ولا غرفة عمليات” ولا يوجد قسم للطوارئ في داريا. فر العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية إلى مصر أو الأردن أو تركيا أو أوروبا ولم يعود معظمهم.
الغطاء الحقيقي الوحيد يأتي من فريق من منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، الملتزمين بإدارة المركز الطبي الوحيد حتى نهاية العام.
لحام مقتنع بأنه لو توفرت خدمات صحية أكثر، “سيعود عدد أكبر من الناس”.
وعندما عاد الدكتور حسام جاموس إلى داريا، لم يتعرف على مدينته. وقال أخصائي الأذن والأنف والحنجرة البالغ من العمر 55 عاماً والذي فر مع عائلته في بداية الحصار عام 2012: “توقعت أن يتم تدميره ولكن ليس إلى هذا الحد”.
بعد أن كانت عيادته مزدهرة مع 30.000 مريض، وجد نفسه في المنفى في الأردن، غير قادر في البداية على العمل كمستشار. فتطوع وأعاد تدريبه وعمل في مستشفى يديره الهلال الأحمر الإماراتي.
لقد عاد بأسرع ما يمكن، وعلق لوحته على المدخل المليء بالرصاص إلى مكان الجراحة.
وفي غضون أسابيع قليلة، عالج مئات المرضى، بدءاً من الأطفال الذين يعانون من التهاب اللوزتين إلى “طبلة الأذن المثقوبة أو المكسورة الناجمة عن الضرب أثناء الاحتجاز”.
وقال: “مثلما خدمت مواطنيي الذين كانوا لاجئين في الأردن، أواصل خدمتهم اليوم في بلدي” أثناء إعادة البناء.
وهذا أيضًا هو هدف الصحفيين في عنب بلدي، وهي وسيلة إعلامية ولدت مع بداية الحرب في داريا، والتي أصبحت منذ ذلك الحين الصوت المستقل الرائد في سوريا.
وقُتل أربعة من فريقها الأصلي المؤلف من 20 فرداً بين عامي 2012 و2016، قبل أن ينقل الناجون غرفة التحرير إلى ألمانيا وتركيا، حيث تم تدريب مراسليها.
لدى عنب بلدي مراسلون من فسيفساء الطوائف السورية – السنة والعلويين والمسيحيين والأكراد والدروز – ولا تخجل من تناول المواضيع الحساسة، حتى عندما يجعل الأمر غير مريح للسلطات الإسلامية الجديدة.
وقاموا بتغطية عمليات القتل الطائفي للعلويين، فرع الإسلام الشيعي الذي تنحدر منه عائلة الأسد، في اللاذقية في مارس/آذار، وكذلك أعمال العنف ضد الأقلية الدرزية في يوليو/تموز في السويداء في الجنوب.
وقال المؤسس المشارك عمار زيادة (35 عاما) وهو يقف أمام أنقاض المنزل الذي نُشرت منه لأول مرة، إنه يأمل أن “تتمكن وسائل الإعلام المستقلة من الحفاظ على مساحة للحرية” في بلد تم فيه إسكات الصحفيين لعقود.
– أطفال مصدومون –
وقال محمد نقاش إنه يريد إعادة طفليه، اللذين ولدا في المنفى في تركيا، إلى داريا حتى يشعرا أخيرا بأنهما في وطنهما – على الرغم من أن المنزل كان في حالة خراب.
ولم يدرك مدى تأثر ولديه عمر، ستة أعوام، وحمزة، ثمانية أعوام، بالعنصرية والعزلة لكونهما لاجئين حتى عودتهما. كان ذلك عندما لاحظ كيف أنهم يواجهون صعوبة في “التواصل مع والدي وإخوتي”، بعد أن تجاهلهم زملاؤهم الأتراك.
خوفًا من أن يكونوا مصابين بالتوحد، أخذهم إلى الطبيب. لكنهم يتأقلمون الآن، ويعودون إلى المدرسة ويتعلمون إعادة تعلم كل شيء، بعد أن تعلموا الأبجدية الرومانية في تركيا.
وفقدت داريا سبعاً من مدارسها الأربع والعشرين في الحرب، وتعاني أيضاً من نقص في المعلمين والمعدات بعد عودة 80% من سكانها قبل الحرب.
ولد العديد من التلاميذ في المنفى في الأردن أو مصر أو لبنان. وقال مسؤول تعليمي إن أولئك الذين يذهبون إلى المدارس في تركيا “يعانون من اللغة العربية التي يتحدثونها ولكنهم لا يستطيعون كتابتها”.
وبعد أن دفن “ثمانية من أصدقائه بيدي” قبل أن يفر، يعمل نقاش (31 عاما) نجارا. إنه يركز على إعادة البناء بكل معنى الكلمة.
مثل كثيرين ممن فقدوا منازلهم، يعيش هو وعائلته الصغيرة مع أقاربهم، ويتنقلون من منزل إلى آخر بينما يظلون على قيد الحياة بعد انتهاء فترة الترحيب بهم.
وقال رئيس مجلس المدينة محمد جانينة: “نتعامل كل يوم مع السكان العائدين الذين يجدون منازلهم مدمرة ويطلبون منا المأوى أو المساعدة في إعادة البناء”.
ولكن لإعادة البناء، يجب أن يكون لديك أوراقك الخاصة، والتي غالبًا ما تكون قد ضاعت في القصف أو أثناء الهروب.
– إخفاء الموتى –
في الأيام الأخيرة التي سبقت سقوط داريا عام 2016، حاول آخر المقاتلين والناشطين المتبقين – بمن فيهم بلال شوربا وحسام لحام – إنقاذ كرامة الموتى.
وقاموا بالتقاط صور للقبور الموجودة في مقبرة الشهداء لجميع من ذبحوا أو قُتلوا خلال الحصار، ثم قاموا بإزالة شواهد القبور في حال تم تدنيسها من قبل مقاتلي الأسد.
وبفضل الصور تمكنوا من وضع 421 شاهد قبر جديد لمن عرفت أسماؤهم.
وفي قطعة الأرض المقابلة، تحت أسِرة من الشجيرات التي يتم الاعتناء بها جيدًا، تكمن المقابر الجماعية لضحايا مذبحة أغسطس 2012، التي لم يتم التعرف عليها بعد، عندما اجتاحت القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها المدينة مما أسفر عن مقتل 700 شخص في ثلاثة أيام فقط.
وقالت آمنة خولاني وهي تحبس دموعها وهي تصلي في المقبرة: “أنا أكافح من أجل إعطاء قبر لإخوتي”.
تم القبض على ثلاثة من إخوتها ولم يتم رؤيتهم مرة أخرى.
وظهرت صورة لأحد هؤلاء لاحقا في “ملفات قيصر” المسربة، والتي تضمنت صورا لبعض الآلاف الذين اختفوا في مراكز التعذيب والاعتقال التابعة للأسد.
وقال خولاني، عضو اللجنة الوطنية للمفقودين، والذي تحدث مرتين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة بالعدالة: “هناك معاناة كبيرة في داريا. الكثيرون لا يعرفون أين أطفالهم”.
وقالت الناشطة التي تقسم وقتها بين بريطانيا وسوريا: “لقد قاتلنا من أجل تخليص أنفسنا من الأسد، لكننا الآن نبحث عن القبور”.
عند مدخل المقبرة، ترفرف في مهب الريح سلسلة من الصور الباهتة للمفقودين، مع لافتة كتب عليها «إنها ليست أرقاما».
رسم بلال شوربا لوحة جدارية على أحد جدران المقبرة. فتاة صغيرة تقطف الورد تخليداً لذكرى والدها، لكن ليس لديها قبر لتضعه عليه.