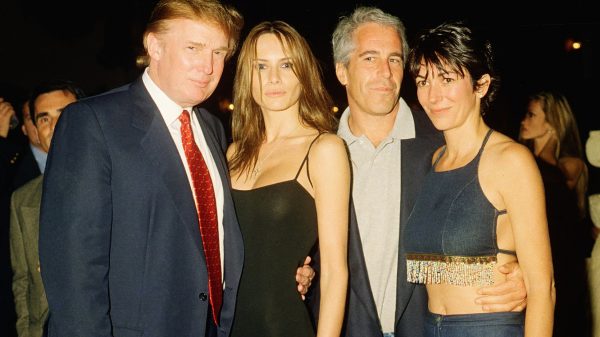لقد اعترفت المملكة المتحدة وفرنسا مؤخرًا بفلسطين كدولة على أساس حدود عام 1967 (قبل بداية حرب الأيام الستة وانتهائها) جنبًا إلى جنب مع غالبية الدول في جميع أنحاء العالم التي فعلت ذلك بالفعل في مراحل مختلفة. ومع ذلك، فإن إحدى نتائج هذا الاعتراف من جانب هذه الدول هي الفكرة، على الأقل من وجهة نظر تلك الدول المعترفة، بأن أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية يعيشون الآن في فلسطين.
وبالتالي، فإن وجود “المستوطنات” الإسرائيلية (لعدم وجود كلمة أفضل لأنه، بالقدر نفسه، يفهم أن مثل هذا المصطلح يمكن أن يجرد الأسر والأطفال الذين ينشأون في مثل هذه المناطق من إنسانيتهم) في الضفة الغربية يظل قضية على أرض الواقع. المستوطنات ليست ثابتة ولكن يُعتقد أنها آخذة في التوسع، وكانت شرعيتها بموجب القانون الدولي قضية مثيرة للجدل.
يحاول هذا المقال شرح وتوضيح مختلف القضايا والمواضيع القانونية ومشاكل التفسير القانوني فيما يتعلق بالأحكام القانونية المركزية المتعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية. وكما سنرى، هناك مواقف ومقاربات متنافسة تجاه الإطار القانوني.
يدور الكثير من الخطاب القانوني حول المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي يُحظر على قوة الاحتلال (إسرائيل) منعا باتا استخدامها نقل قسري السكان المدنيين في الأراضي المحتلة (في هذه الحالة، الضفة الغربية).
وتنص الفقرة الأولى من المادة 49 على ما يلي:
يُحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك عمليات ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دوافعها.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 49 على ما يلي:
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
الموقف الإسرائيلي، في البداية، هو أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لا تنطبق على الضفة الغربية. ‘مشغول’ إقليم ولكن “متنازع عليه” وأن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق إلا على “الأراضي المحتلة” بواسطة “قوة الاحتلال”.
وفي هذا الصدد، تشير إسرائيل إلى أنها لم تسيطر على الأراضي في عام 1967 نتيجة لحرب ‘جارح’ الحرب أو الصراع من جانبها. وبدلاً من ذلك، تعرضت (إسرائيل) لهجوم من قبل جيرانها في عام 1967 (كما كان الحال في عامي 1948 و1973) وشاركت، قسراً، في عملية عسكرية. ‘دفاعي’ الصراع الذي حصلت فيه على هذه الأرض نتيجة للدفاع عن نفسها من تهديد وجودي.
علاوة على ذلك، تشير إسرائيل أيضًا إلى أن أراضي الضفة الغربية، حتى قبل عام 1967، كانت تحت السيطرة الأردنية وليس تحت سيطرة دولة مستقلة أو ذات سيادة، وبالتالي، يمكن اعتبار الأردن قوة احتلال بحيث لا ينطبق الإطار المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة.
ويسعى هذا الخط من الحجة، الذي طرحته إسرائيل، أيضًا إلى الاعتماد بشكل وثيق على صياغة المادة 2 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تشير إلى نزاع مسلح من قبل “طرف سام متعاقد”. والحجة هي أن فلسطين، التي كانت تفتقر إلى الاستقلال في ذلك الوقت، لم تكن ولن تكون طرفاً سامياً متعاقداً، وأن الضفة الغربية كانت تحت السيطرة الأردنية حيث كان الأردن هو المعتدي في صراع عام 1967.
هناك العديد من الحجج القانونية الأخرى الصادرة من إسرائيل، لكن ما ورد أعلاه يقدم نكهة موجزة للموقف الإسرائيلي.
ومهما بدت هذه الحجج جذابة من موقف قائم بذاته، فقد تم رفضها أو أنها لم تجد آذاناً صاغية كما وصفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واعتبر أن الضفة الغربية هي الضفة الغربية. “الأراضي المحتلة”.
علاوة على ذلك، وصفت المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها الضفة الغربية (أو يهودا والسامرة) بأنها أرض خاضعة للسيطرة “في الاحتلال الحربي”. وأخيرًا، رأت محكمة العدل الدولية أيضًا في فتواها الصادرة في يوليو/تموز 2004 أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) باعتبارها أرضًا “محتلة”.
وعلى هذا الأساس، يبدو أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق وأن الضفة الغربية هي أرض محتلة لا تنتمي إلى إسرائيل وأن المستوطنين جزء من نظام نقل السكان.
ومع ذلك، هذه ليست نهاية الأمر. تشير المادة 49 إلى مفهوم أ “النقل القسري”. وستشير إسرائيل بعد ذلك إلى المستوطنات باعتبارها لا ترقى إلى مستوى المطلوب “النقل القسري” من سكانها المدنيين (أو من السكان الفلسطينيين). ويستند هذا الخط من الحجة إلى نقطة مفادها أن العديد من المستوطنين الإسرائيليين اختاروا، في الواقع، العيش في الضفة الغربية ولم يتم تشجيعهم على القيام بذلك أو إخبارهم بشكل مباشر بذلك من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وبدلاً من ذلك، ينتقل العديد من المستوطنين الإسرائيليين إلى الضفة الغربية بمحض إرادتهم إما عن طريق الاستيطان الجماعي أو عن طريق شراء الأراضي من الفلسطينيين بأسعار، في سياق مستويات المعيشة الفلسطينية، هي ببساطة أفضل من أن يتم رفضها.
وبعبارة أخرى، فإن إسرائيل لا تجبر أو تستخدم القوة ضد سكانها للانتقال إلى الضفة الغربية، كما أنها لا تجبر الفلسطينيين (المزارعين عادةً) على بيع أراضيهم للمستوطنين.
الحجج الفلسطينية المضادة هي كما يلي.
النقطة الأولى التي يجب الإشارة إليها هي أن الكلمة “قسري” ينبغي تفسيرها على نطاق واسع. في الواقع، تنص المادة 6 (هـ) من نظام روما الأساسي، أركان الجرائم، على أن كلمة “قسراً”…
(…) لا يقتصر على القوة البدنية، بل قد يشمل التهديد باستخدام القوة أو الإكراه، مثل ذلك الناجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد هذا الشخص أو الأشخاص أو شخص آخر، أو عن طريق الاستفادة من بيئة قسرية.
لقد تم بالفعل تطبيق هذا التعريف الواسع في محكمة دولية وهي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية المدعي العام ضد سيميتش وآخرين، 2003. القضية رقم IT-95-9-T حيث ذكرت المحكمة؛
(…) عند تقييم ما إذا كان تهجير شخص ما طوعيًا أم لا، ينبغي (للمحكمة) أن تنظر إلى ما هو أبعد من الشكليات لتشمل جميع الظروف المحيطة بتهجير الشخص، للتأكد من النية الحقيقية لذلك الشخص.
ويمكن الاستدلال على عدم وجود خيار حقيقي، في جملة أمور، من أعمال التهديد والترهيب التي تهدف إلى حرمان السكان المدنيين من ممارسة إرادتهم الحرة.
وبالمثل، في قضية المدعي العام ضد بلاغوجيفيتش، 2005. القضية رقم IT-02-60، قيل أيضًا؛
وحتى في الحالات التي قد يكون فيها النازحون قد رغبوا، أو ربما طلبوا في الواقع، إبعادهم، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنهم كان لديهم خيار حقيقي أو مارسوه. وبالتالي، يجب على القائم بمحاكمة الوقائع أن يأخذ في الاعتبار الوضع السائد والأجواء السائدة، فضلاً عن جميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص ضعف الضحايا، عند تقييم ما إذا كان لدى الضحايا النازحين خيار حقيقي للبقاء أو المغادرة، وبالتالي ما إذا كان النزوح الناتج عن ذلك غير قانوني.
وبعبارة أخرى، عند تقييم ما إذا كان هناك “نقل قسري” لأي مجموعة من السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة، يتعين على المرء تطبيق تعريف واسع لكلمة “القسري”. ولا يقتصر المصطلح على القوة المباشرة المطبقة على النقل.
ومن الناحية القانونية، يتعين على المرء أن يدرس جميع الظروف المتعلقة بما إذا كانت قوة الاحتلال (أي إسرائيل) قد خلقت بيئة بحيث يتعرض السكان المحليون لبيئة قسرية، حيث، في الواقع، الظروف الاقتصادية والاجتماعية تجعل السكان المحليين ليس لديهم خيار حقيقي أو إرادة حرة في أي معاملة (على سبيل المثال، بيع الأراضي للمستوطنين).
علاوة على ذلك، يشار أيضًا إلى أن إسرائيل قسمت الضفة الغربية إلى مناطق مختلفة وأنشأت العديد من نقاط التفتيش والقيود على حرية الحركة بحيث يعيش السكان المحليون في بيئة قسرية غير مواتية اجتماعيًا واقتصاديًا. وهذه البيئة، التي تلخص انعدام الاستقرار، تجعل الفلسطينيين ليس أمامهم خيار سوى بيع أراضيهم، أو لا يملكون، بخلاف ذلك، القدرة اللوجستية على منع واضعي اليد من الاستيلاء على الأراضي، أو إنفاذ حقوقهم. وبالتالي، حتى لو لم تصدر إسرائيل تعليمات لواضعي اليد أو المستوطنين بالتحرك، فيمكن القول إن حكمها أو تقسيمها للضفة الغربية إلى مناطق مختلفة يخلق الظروف المثالية لنقل السكان.
إذا كان هذا صحيحاً (أي أن إسرائيل خلقت مثل هذه البيئة القسرية لإزالة الاختيار الحقيقي)، فقد تشير إسرائيل إلى حقيقة أن البيئة الحالية لنقاط التفتيش والقيود في الضفة الغربية ضرورية لأمنها.
قد تكون هذه نقطة صحيحة فيما يتعلق بهذه القضية المنفصلة (الأمنية)، لكن هذا في حد ذاته لا يعني أن تبني مثل هذه التدابير الأمنية كجزء من أي حق في الدفاع عن النفس، يعني عدم انتهاك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة إذا لم يتم إيقاف المستوطنين اللاحقين.
هذه هي القضية الأساسية فيما يتعلق بالنقاش العام حول شرعية المستوطنات في الضفة الغربية. هذا سؤال قانوني لا يمكن الإجابة عليه بسهولة دون الخوض في تحقيق وفحص واقعي للحياة اليومية داخل الضفة الغربية.
وبطبيعة الحال، سيكون مثل هذا التحقيق صعباً لأن أي مستفسر (سواء كان فرداً أو منظمة) سيُتهم بلا شك ببعض التحيز السياسي أو عدم التحيز من قبل جانب واحد على الأقل.
وهكذا، يحتدم النقاش (القانوني والسياسي على حد سواء).