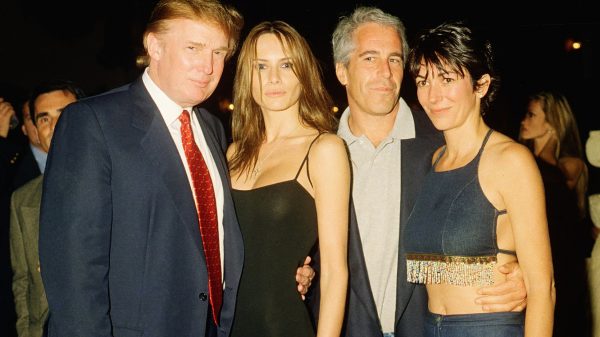عندما يعبر الفراغ الطائفي والسياسي عن نفسه بغطرسة، فأنت تتحدث حتماً عن عراق اليوم المزيف.
نوري المالكي لا يشعر بالخجل من ارتداء شارة العار كإنجاز طائفي. فهو في موقفه المشين القديم الجديد، الذي يروج لنفسه للانتخابات النيابية المقبلة، يعرّف الوطنية العراقية بأنها دعم العملية السياسية التي بدأت منذ احتلال العراق، وهو تصريح لا يحميه من عواقب حماقته الوطنية.
ويزعم المالكي أن أنصار النظام الحالي “وطنيون”، ويصر على أن الفوز بالدعم الشعبي يجب أن يرتكز على مبادئ القانون والعملية السياسية. ومع ذلك فهو لا يستطيع الدفاع عن جوهر هذا القانون، سواء كان حقيقياً أو مزيفاً مثل كل شيء آخر في العراق اليوم.
ويعكس خطابه تصريحه التاريخي السيئ السمعة الذي قسم العراقيين إلى جيش الحسين وجيش يزيد. ولكنه يكشف أيضاً عن حقيقة أعمق: فهو يعلم، في أعماقه، أن لا أحد من العراقيين يثق به حقاً. فهو يعيش أزمة نفسية متنامية ترجع جذورها إلى ما يمكن أن نطلق عليه “سلسلة الإعدامات” التي يبدو أن مصيره الطائفي البائس ينتظرها.
ويحمل المالكي شكاً غريزياً تجاه السُنّة، وهو الشعور الذي كثيراً ما كرره في اجتماعاته مع مسؤولي السفارة الأميركية، والذي أعرب عنه ذات مرة للرئيس السابق جلال الطالباني بازدراء تجاه أهل الموصل الشرفاء، لمجرد أنهم من السُنّة.
انظروا مرة أخرى إلى صورته وهو يحمل بندقية، كالجندي المهزوم، بعد أن حاصر أتباع التيار الصدري المنطقة الخضراء. يكشف عن مشاعره وهزيمته المبكرة وما يتوقعه بعد ذلك.
منذ سقوط الموصل بيد داعش، يعيش المالكي أسوأ أزماته الشخصية، يعبر عنها بالثرثرة السياسية، كمن يربط جرساً حول رقبته ليهدي المنتقمين إليه. وكما قال السفير الأميركي السابق ريان كروكر ذات مرة، فإن المالكي يرى بعثياً يتربص خلف كل شجيرة. وتشاهد الولايات المتحدة هذه “الدراما المفعمة بالحيوية” و”الكوميديا الساذجة” وهي تتكشف في المنطقة الخضراء.
يومًا بعد يوم، نكتشف أن المالكي يعتقد حقًا أن جنودًا من جيش يزيد يخرجون من صفحات التاريخ لينصبوا له كمينًا خلف كل شجيرة.
وقد نصح الرئيس بوش ذات مرة المالكي بعدم مطالبة مساعديه بترجمة مقالات الصحف الأميركية له. لن يساعدوا تفكيره الضحل.
أي نوع من السياسيين، بكامل قواهم العقلية، قد يعبر بكل هذه الوقاحة عن فساده من خلال وصف العراقيين الذين يرفضون الفساد ويطالبون بعودة دولتهم المختطفة بأنهم “غير وطنيين”؟
وبالعودة إلى المعضلة الأخلاقية والشخصية التي يعيشها هذا السياسي الطائفي، يصبح الجواب واضحاً: تاريخه كله وصمة عار ومهانة للدين باسم الدفاع عن طائفة.
ذات مرة، قال أحد الرومان لصانع أحذية سمح للغطرسة بالتغلب عليه: «لا يتجاوز صانع الأحذية حذائه».
كم مرة يجب أن نكرر هذه العبارة أمام النماذج السياسية المبتذلة والمتغطرسة في المنطقة الخضراء، من نوري المالكي ومحمد شياع السوداني إلى عمار الحكيم وقيس الخزعلي ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر ومحمود المشهداني وهادي العامري؟
سوف يُذكر المالكي باعتباره واحداً من أكثر السياسيين تدميراً في تاريخ العراق، حيث كان يتوقيت نشر وصفاته المدمرة كلما شعر بالتهميش. إنه يتوق إلى أن يكون مركزياً، ويمنح نفسه الحق، كمفكر ذي عقلية مقبرة، في أن يكون حاضراً في تاريخ عمره ألف عام، ويتحدث مثل أي عقل طائفي كما لو كان شاهداً على ذلك الماضي، ويشكل الوطنية العراقية وفقاً لذلك.
والأسوأ من تصريحاته الأخيرة حول ربط الوطنية بدعم العملية السياسية هو حقيقة أن البعض يعبر عن دهشته لكلماته، بدلاً من الاعتراف بها على أنها ازدراء محض.
لكن هذا هو النموذج السائد لدى الساسة العراقيين. وكما يقول صديقي الكاتب علي الصراف: هم والخداع واحد. المالكي ليس فريدا من نوعه، لكنه النموذج الأولي. “أبو” الطائفية، ومهندس الحكم على أساس المحاصصة، وقائد دولة هويتها الوحيدة هي الفساد.
وفي «الدولة» التي رعاها المالكي، تُستبعد المسألة الوطنية. بل إن البعض يسخر من فكرة الوطنية، ويرى أنها شيء يجب استئصاله. ولهذا شعر المالكي وأمثاله بالتهديد عندما رفع شباب تشرين شعار:
“نريد وطناً”
مشكلة المالكي هي أنه لا يرى نفسه نفايات طائفية. وهذه أزمة أخلاقية قبل أن تكون سياسية. ولن يرى طبيعته الحقيقية إلا عندما يبدأ العراقيون في تنظيف حطام وطنهم المسروق.